منتهى ناصيف
إنّه يوم الجمعه الموعود، أصعد في الحافلة التي خصصت لنقل المحتجين والمحتجات إلى الساحة، أجلس إلى جانب امرأة لا أعرفها، تتعالى أصوات الركاب وتختلط بينما هم يتبادلون التحية، وما أن تنطلق الحافلة حتى تنطلق معها أغنية شعبية تجعل غالبية الركاب يصفقون ويهزجون معها في حماسٍ كبير.
منذ بداية الحراك وأنا أتساءل عن سبب ارتباط الاحتجاجات بالأهازيج الشعبية والدبكة، ربما لأن الحرية مرتبطة بالفرح، ونحن مثل كل المحرومين والمهمشين نحتاج لهذه الفرصة كي تعلو أصواتنا لتعانق السماء، نحتاج أن نضرب الأرض بأقدامنا سويةً لنؤكد على وجودنا كبشر نستحق الحياة، أو ربما لأننا لم نعد نمتلك وضوحاً لمشاعرنا، نضحك ونبكي في ذات الوقت، نغضب ونسامح، نتربص لبعضنا ونجامل هشاشتنا، نتخبط كل لحظة غير مدركين مبتغانا، نتطلع متحسرين إلى إدلب وغزة، متسائلين إن كان هناك أمل في إيقاف البؤس على هذه البقعة الجغرافية التي تنز بالوجع والخوف والقهر والدمار.
ما أن تنطلق الحافلة حتى تنطلق معها الزغاريد من المقعد الخلفي في الحافلة، والمرأة إلى جانبي تطلق فجأة زغرودة طويلة صاخبة. كم تمنيت لو كنت أعرف كيف أزغرد مثلهن، أن أفتح العنان لصوتي وأراقب هذا الرنين المدهش وهو يخرج من حنجرتي، لكنّي لم أتعلمها مطلقاً، وفي المرات القليلة التي جربت فيها، باءت محاولاتي بالفشل بعد أن خرج صوت يشبه الصرير المخنوق، ربما لأنه في المرحلة التي كان يمكن فيها أن أتعلم كيف أزغرد وأهزج وأرقص مثل كل الفتيات كان هناك شيء آخر يشغلني.
عائلتي كانت تمر بظرف إستثنائي ولم تكن حياتنا تتسع لهذا الترف، بعد أن تم اعتقال أختي الكبيرة فجأة. كان ذلك أيضاً في صباح يوم جمعة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يتجاوز عمرها التاسعة عشر وتنهي سنتها الجامعية الأولى، اقتادوها ببرود أمام أعين الجميع وأمام عيني أمي اللتان غاراتا في حزن عميق الى الأبد.
كنت أصغر من أن أسأل عن السبب وأن أدرك ما يحصل، لكن صرخة أمي التي اهتزت لها جدران بيتنا، جعلتني أعلم أن حياتنا لن تشبه حياة من حولنا بعد اليوم.
ومن يومها لم يعد يوم الجمعة يوماً عادياً، فقد ارتبط بالنسبة لي بالترقب والقلق وبالانتظار، ولمدة أكثر من أربع سنوات تعودت أن أجلس على الشرفة وأنتظر أن يعود صوت أمي كالسابق وأن تعود أختي ورفاقها من المعتقل.
ما أشد الفرق بين تلك الأيام ويومنا هذا، كلمة “حرية” التي دفع أختي ورفاقها سنين من أعمارهم في المعتقل وخسر الكثيرون حياتهم من أجلها وهجر بسببها الملايين، ها هي تخرج من حناجرنا مجدداً مثل بركان انفجر فجأة، الكثيرون في الساحة يكتبونها على صدورهم، على الكراتين واللوحات، كلمة “حرية” الثمينة، الغالية جداً، يرددها كبار السن والأطفال والمراهقين، يحيون معناها وكأنهم يعوضون بها كل الحرمان وكل الخسائر، هي وحدها القادرة على أن تحيينا مجدداً.
العسكر لم يتدخلوا حتى الآن! لم يرشونا بالرصاص كما فعلوا قبل اثني عشر عاماً، ولم يقبضوا علينا، نتهامس فيما بيننا أنهم ربما هذه المرة يجربون طريقة جديدة للتعامل معنا، ربما اختاروا تجاهلنا، أو المراهنة على صمودنا في الساحات، يتعاملون معنا كأننا أشباح تعيش في كوكب آخر، وربما يتجهزون للرد علينا بطرق أكثر جديّة، كل الاحتمالات ممكنة.
أجفلني صوت المرأة بجانبي، يبدو أنها كانت تراقبني وأنا غارقة في أفكاري عندما نكزت كتفي وقالت: “يللا غني معنا شو انتِ جاي على عزاء؟”
كلماتها وطريقتها جعلتني أتساءل عن معنى وجودي في تلك الحافلة، وعن سبب عدم قدرتي مثلهم على الغناء والفرح، ألم يرتبط عندي الاحتجاج بالخوف والحزن؟
تذكرت تلك الورقة التي قررت أن أرفعها بالساحة، فكرت بما يمكن أن أكتبه عليها، وبأي مطالب أبدأ، خطرت لي الكثير من الكلمات ولكني عجزت أن أختار واحدة منها، ولمت نفسي لأنني قد لا أستحق هذا الترف العظيم بالتعبير، لم أتوقع أن أمتلك هذا الخيار يوماً، ولم أستعدّ لهذا الأمر بتاتاً، تعودت أن أخفي كتب أختي وأوراقها بمكان قصي، وأن أكتب عن الحرية بخط صغير يشبه الرموز بحيث لا يفهمها أحد، فالخوف كان قد اخترق عظامي، أصبح توأمي، فأنا حتى وقت قريب لازلت أسمع أغاني الشيخ أمام بصوت خافت، وأغلف الكتب الممنوعة قبل أن أقرأها!
أبو خالد، رجل أعرفه من الحي، يقف أمامي، يراقب مثلي الركاب وهم يهزجون ويهتفون بحماس، كان ينظر إليّ نظرة العارف بما يجول في خاطري، فهو أيضا لم يكن يشاركهم الغناء، ربما لم يحظ أيضاً بفرصة أن يكون حراً ويهتف بما يوجعه، وأن يقول ولو مرة ما يتمناه. كان مثلي غارقاً في صمته عندما أتاه فجأة ذلك السؤال الغريب من أحد الشبان الواقفين في منتصف الباص: “إنت راكب أم ثائر؟”
أجفلني سؤاله، فأنا أيضاً لا أعلم بما أجيب! لا أعلم ما الذي يقودني كل يوم جمعة إلى تلك الساحة، ومفردة ثائر كبيرة جداً ومرعبة! كيف أعرف هل أنا ثائرة أم مجرد راكبة في حافلة أشبه ما تكون بسفينة تتخبط وسط المحيط وتحاصرها العاصفة من كل الجهات.
وعلى الرغم من نظرات الجميع وترقبهم للإجابة بقي أبو خالد صامتاً، نظر نظرة حزينة ثم أمال رأسه نحو النافذة وتابع مراقبة الطريق المتصحر.
ربما لا نحتاج أن نفكر الآن بأي شيء سوى التجديف معاً ولو بأيدينا لعلنا نصل لشاطئ النجاة.
“كلنا ثائرون بعون الله”، أتت إجابة من إحدى النساء في المقعد الخلفي لتنقذ أبو خالد من حرجه.
وما أن وصلت الحافلة للساحة حتى سرنا جميعا سوية بخطوات تكاد تكون على إيقاع الأهازيج، وأبو خالد كان أمامي يسير بخطوات ثابتة يهز رأسه على إيقاع الهتاف دون أن يخرج أي صوت، ولكن دموعه كانت كافية لتجيب عن ذاك السؤال.
سرتُ معهم نحو الساحة لعلي أملأ فراغ لوحتي البيضاء بحروف ونقاط وكلمات، أريد أن أركل الخوف بعيداً وأعطي جواباً أكيداً للسؤال.
أغمضت عيني وأكملت السير، محاولة ان أتنفس بحرية، كي أستعيد ملامح أختي البعيدة، وصوت أمي الغائب وبعض الفرح المنشود.
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”


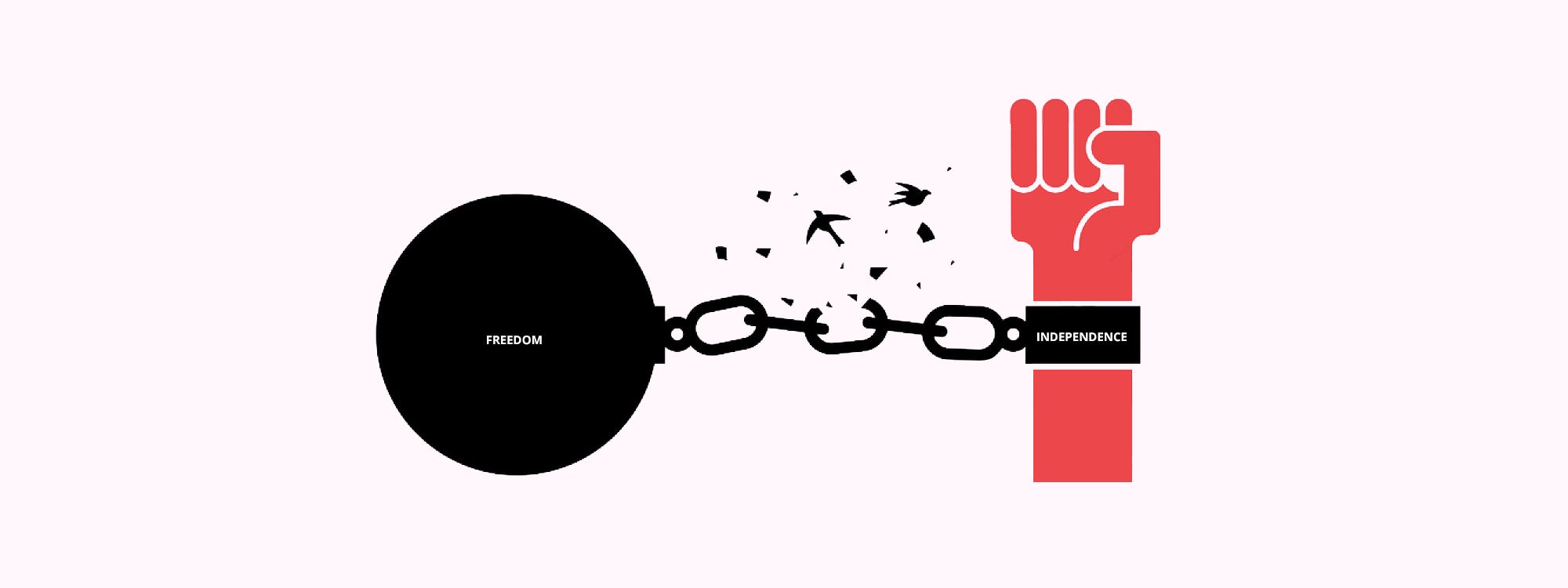




2 Responses
قصّة تحاكي الواقع بصدق وتستطيع أن تصل إلى أعماق المشاركين بالحراك .
ولكنّني أتساءل ..ألا يوجد تدقيق للنصوص قبل النشر ؟ هذا لتأتي النصوص على الوجه الأكمل .
من الأخطاء الواجب تصويبها ..
استثنائي..
ما إن .
التاسعة عشرة .
الثمانينيات .
أمام عينيْ أمي اللتين .
التي دفعت أختي ورفاقها .
هاجر الملايين .
والمراهقون .
نتهامس إنّهم .
توءمي .
الشيخ إمام .
أنقذت أبا خالد .
طبعا هذا من دواعي حرصي على ااشبكة .
وشكرا لجهودكم .
لقد أرسلت بعض الملاحظات أرجو أن تكون قد وصلت