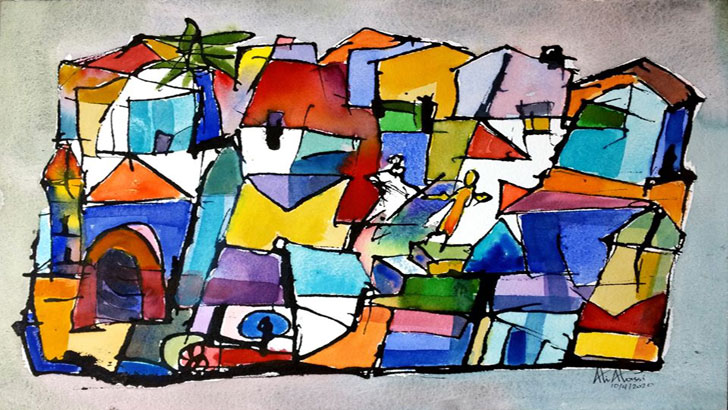دمشق – دلال عبد الله
كانت الإجازة والبقاء في المنزل بمثابة رفاهية لذوي الوظائف الحكومية والخاصة في سوريا؛ للتخفف من عبء العمل المرهق، أو ساعات الدوام الطويلة. لكنها تحوّلت اليوم إلى كابوس مرعب، فقط لأنها أمر إلزامي يحدّ من نشاطهم. وكلّ المشاريع المؤجلة التي كانوا ينتظرون الإجازات لإنجازها، باتت غير قابلة للتطبيق مع هذا الكم الهائل من الوقت، الذي أتيح لهم للبقاء داخل جدران منازلهم مرغمين بسبب تفشي فايروس كورونا في العالم، وحصدهِ لأرواح الآلاف.
وسوريا بحكم موقعها بين بلدان أعلنت عن ظهور إصابات بالفايروس على أرضها، اضطرت لاتخاذ إجراءات وُصفت بالاحترازية، لمواجهة هذا الفايروس، من إيقاف للكثير من الأعمال والنشاطات بمختلف أنواعها، يرافقها الحدّ من حركة الناس ووسائل النقل والمواصلات، بشكليه الجزئي والكامل. وتزامن ذلك مع التشديد عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من تنظيف وتعقيم، والامتناع عن التواصل الاجتماعي، بما في ذلك السلام والعناق والقبل، ثم الالتزام بالمنازل لاتقاء وصول فايروس كورونا إليهم.
لذا فإن كورونا لم يرسم الحدود بين المدن والمحافظات فحسب، لكنه رسم حدوداً بين الأقارب والأصدقاء، وأفراد العائلة الواحدة، فقد حلّ الخوف بينهم، سواء خوفهم من الآخر أو عليه. وبالطريقة نفسها التي واجه بها السوريون قسوة تسع سنوات من الحرب، عايشوا فيها الموت، أو اقتربوا منه ولامسوه، سخروا من الفايروس، ولم يصدقوا فكرة أنه قادر على إبقائهم في منازلهم، مما جعلهم غير مبالين نوعاً ما تجاه تنفيذ تلك الإجراءات. هذه السخرية التي تدل كذلك على فقدان ثقتهم بحكومتهم، وتدني مصداقيتها بالنسبة لهم بعد تلك الحرب- على الرغم من أن هذه الإجراءات سواءٌ كانت متأخرة للتغطية على إصابات موجودة، أو استباقية للوقاية من فايروس كورونا، هي خطوات جيدة- ناهيك عن أن الحرب جعلت الكثيرين يتجهون إلى أعمال يومية بسيطة، بالكاد تضمن لهم قوت يومهم؛ ليقاوموا عضّ الجوع لأمعائهم، الأمر الذي جعلهم يستمرون بالخروج للشارع للعمل، في ظل حكومة لا تؤمّن لهم حاجاتهم اليومية للحياة.
البعض يفتح محله خلسةً، ويقدّم الخدمات للناس، والبعض الآخر يلتقط صوراً لمحتويات محله، وينشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، متعهداً لزبائنه بإيصالها إليهم. يقول جلال صاحب إحدى المكتبات، بأنه يبيع الكتب ويعيرها لزبائنه مقابل رسم شهري، لذا فهو يأتي لمحله بناءً على اتصالهم، وينزل (جرار/غلق) المحل حتى منتصف الباب وكأنه مغلق، ويقوم ببيعهم أو إعارتهم الكتب التي يحتاجونها، ثم يعود لمنزله. وهذا حال كثيرين يعمدون لهذه الحيلة ليستمر عملهم، وبالتالي رزقهم.
أما أبو محمد الذي يملك سيارة (سوزوكي) ويدور بها في الأحياء ليشتري من الناس الأشياء التالفة، أو التي لم يعودوا بحاجة لها من نحاس وألمنيوم، وخبزٍ يابسٍ وغيرها، حيث تشكل تلك الأشياء مصدر رزقه وقوت عياله، لذلك لن ينصاع للتعليمات التي تقول بوجوب بقائه في البيت، يقول: “إذا بقيت في البيت، من أين آكل أنا وأولادي؟”.
ومثله صاحب محل للحلاقة الرجالية، فتح محله دون أن يكترث لقرار إغلاق المحلات، وحين سأله أحد زبائنه عن إمكانية أن يتعرض محله لخطر المخالفة أجاب: “خليهم يبلطوا البحر، صرلي عشر أيام مسكر، وما في مصاري، بدنا ناكل، إذا بدهن يخالفوني رح أطلب منهم يعطوني مصروف للبيت والعيلة بعدين بسكر”.
بالمقابل، هناك محلات يتمتع أصحابها بقسط وافر من المال والنفوذ، واستطاعوا التحايل على الوضع. محل لبيع الأدوات والمواد الخاصة بالتجميل وصالونات الحلاقة، حصل على رخصةٍ لبيع الكحول الطبي، من مسؤول في إحدى المحافظات، حيث يبيع (200 ليتر) يومياً بسعر (2000 ل.س) لكل ليتر، بالتالي فإن قيمة مبيعه اليومي من الكحول فقط، يعادل مائتي ألف ليرة سورية، علماً أن بقية محتويات محله لم تتأثر بأمر الإغلاق، ومازال يتابع نشاطه التجاري. محل آخر لبيع أدوات التجميل حصل على ذات الرخصة، وعلّق على واجهة محله ورقة يعلن فيها عن توافر الكحول ومواد التنظيف، وبضاعة محله قابلة للعرض والطلب دون أن تتأثر.
فهل سيعطي المسؤول في المحافظة -الذي لا بدّ أنه قبض حصته من أصحاب تلك المحلات ليعطيهم الترخيص ببيع الكحول- المصروف لصاحب محل الحلاقة وغيره ممن تضررت أعمالهم، ليتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذه البلاد؟
تناقض
مع ذلك كله، تطالب الحكومة الناس بالمكوث في منازلهم من جهة، ومن جهة أخرى تقودهم إلى التجمع في طوابير الخبز والمؤن الضرورية للمنزل. فأسعار السوق المرتفعة التي لا تجد من يكافح جشع تجارها، تجعل الناس يتحملون ازدحام أماكن توزيع الخبز، والمؤسسات الاستهلاكية التي تبيع الزيت والسكر والأرز بأسعار أرخص، بالتالي يخرقون أهم شرط للسلامة وهو وجوب عدم التلامس، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لا يقل عن المتر، ومعظمهم لا يرتدي القفازات والكمامات لفقدانها وغلاء أسعارها أيضاً.
أم بشير، أم لثلاثة أطفال، توفي زوجها خلال الحرب، تقول أنّ الأسعار مرتفعة جداً، ولم يعد لها قدرة على شراء حتى الأشياء الضرورية، تقول: “لولا أهل الخير لمتنا جوعاً أنا وأولادي”. وأم بشير ليست الوحيدة، فخط الفقر الذي رسمته الحرب ليُغرق ما يزيد عن 80% من السوريين تحته، جعلهم يعيشون أسوأ الظروف مع شحّ في الموارد الأساسية للحياة، من مؤن وغاز ومازوت، في ظلّ فساد وجشع قتل كلّ شيء جميل بداخلهم.
كلّ هذه الظروف وغيرها جعلت الإجراءات مثار سخرية، وأضحت معها قصة الحكومة أشبه بقصة الراعي الذي يخبر أهل القرية عن هجوم الذئب على أغنامهم، ويتبين كذبه في كلّ مرة، لكن حين هجم الذئب فعلاً لم يصدقوه، وشبح كورونا يحصد أرواح الناس في العالم، مما يجعل الناس في سوريا خائفين بنفس الوقت، خاصةً بعد ظهور عدد من الإصابات والوفيات، التي يُعلن عنها وسط تكتم شديد على ظروف كل حالة، الأمر الذي خلق حالة من التوتر، وكرّس عدم الثقة بالحكومة بشكل أكبر.
سليم موظف في أحد المشافي، مضطر للذهاب إلى عمله في العاصمة كل يوم، وبعد حظر التنقل بين الريف والمحافظة، عليه أن يأخذ سيارة أجرة للوصول إلى عمله والعودة منه، وهذا يرتّب عليه أعباءً مادية كثيرة، لا يحتملها راتبه المتواضع مع المصاريف الأخرى، في ظلّ غلاء الأسعار المخيف، بالإضافة للضغط الكبير الذي يتعرّض له بسبب عمله، فرغم أنه يعمل في أحد أهم المشافي في العاصمة، لكنه يعترف أن الإجراءات المتبعة لا تكفي في حال تفشي المرض، ذلك أنّ المشافي غير مؤهلة، وغير جاهزة لمحاربة هذا الفايروس.
منظومة هشة
الحرب قضت على المنظومة الطبية والصحية في البلاد، وبات جسم هذه المنظومة هشاً، غير قابل لاحتواء الأزمات والأوبئة. لذا تلجأ الحكومة إلى السرية والكتمان فيما يخص الإصابات وظروفها، وهذا ما تؤكده ميس وهي ممرضة تعمل في أحد المشافي أيضاً، حيث تلقت مع زميلاتها توجيهات صارمة بما يخص هذا الأمر، وأنّ أي تسرّب للمعلومات بخصوص أي إصابة محتملة، ستكون هي وزميلاتها المسؤولات عن ذلك التسريب، ومن المؤكد أن هذه التوجيهات قد عُممت على كلّ مشافي البلد ومراكزه الصحية.
هذا الأمر جعل السوريين يتلقفون كل جديد على وسائل التواصل فيما يخص هذا الوباء، رغبةً في الحصول على معلوماتٍ أكثر، وبالتالي فهمٍ أكبر.
إلا أنهم مع ذلك قد انقسموا إلى فئتين، الأولى أخذت الأمر على محمل الجد، وصبّت معظم جهدها في محاولة اتقاء هذا المرض من نظافة وتعقيم، والتزام بالمنزل، بالإضافة إلى نقل خبراتها وتجاربها للآخرين، فعملت دور الناصح، لدرجة أنك تجزم أن نصف السوريين أصبحوا ضليعين بالشأن الطبي، وكيفية مقاومة الفايروس ومنع تفشيه، وهي نفس الفئة التي تحولت في سنوات الحرب إلى محللين سياسيين وإعلاميين، تكتب وتصور وتسجل آراءها ومواقفها، وهو أمر طبيعي في زمن العولمة، وإن لم يكن صحيحاً لدرجة كبيرة.
أما الفئة الثانية، فهي التي استسلمت لقدرها، واعتبرت ذلك غضباً من الرب ينبغي معه الدعاء والصلاة، وطلب الغفران والرحمة من الخالق، لما اقترفت أيدي البشر من أخطاء استوجبت هذا العقاب.وكلا الفئتين وجدت من يستثمر فيهما، فالخوف أكثر العملات التي يستطيع رجال الدين، ورجال السياسة والمال الاستثمار فيها.
نظرية المؤامرة
لذا من الطبيعي أن تنتشر نظرية المؤامرة، وتجد من يؤيدها، وتظهر الجماعات التي تسعى للشهرة على مواقع التواصل، لتزيد عدد مشاهداتها، عدا عن الذين يحترفون النصب والاحتيال. كما ستجد فكرة أنّ الدول الأوربية تسعى للتخلص من مسنيها، جمهوراً يهتم بها ويروّج لها، بالإضافة إلى من يحذرون من اقتراب نهاية العالم، وأن غضب الطبيعة سيبتلعه. وغير ذلك الكثير من مفرزات ظهرت وستظهر حتى ينتهي دور الفايروس في تغيير وقولبة البشر، المبنية على الخوف منه، ويجد العلماء والأطباء علاجاً ناجعاً يحدّ من خطره وسطوته.
حتى ذلك الوقت سيكون له دور في تغيير أنماط كثيرة من العادات، والمرحلة القادمة من الحظر في سوريا ستكشف الكثير من التغييرات، فقد تُخرج إصابات جديدة الأمور عن السيطرة، وربما لا يحدث شيء من هذا.
والسؤال هل استعدّ السوريون جيداً لهذه الاحتمالات؟
إن ظهور إصابات جديدة سيجعل الكثيرين يدركون أنّ عليهم التزام منازلهم، لكنه سيكون التزاماً ناجماً عن الخوف وليس الوعي، وهذه مصيبة على السوريين التفكير بها.
كما لا يمكن الجزم بشكل وملامح حياتهم، وطريقة تفكيرهم حين تنتهي هذه الجائحة، ويعودون لحياتهم الطبيعية، وهل ستكون طبيعية؟ هل سينفتحون على الحياة بشكل آخر، تبعاً لنمط تفكير مختلف أفرزته هذه العزلة، التي لا أحد يعرف كم ستكون مدتها؟
إلى أي حدّ قد تجعلهم هذه الإقامة الجبرية، قادرين على رؤية ألوان أخرى للحياة، وتقديرٍ للوقت الذي بين أيديهم من قبل ومن بعد؟ وهل سيطلقون العنان لأفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم، باتجاهات مختلفة تخدم مجتمعهم؟ هل سيعوضون الوقت الذي ضاع منهم، أم سيعودون لعاداتهم القديمة انتقاماً من سلوكيات فُرضت عليهم، ولم تصل للحد الذي يجعلها عادات مُكتسبة ذات قيمة، من عناية ونظافة، ومراعاة للآخر؟
أخيراً، هل سيتجاوز الكثيرون خوفهم، أم أنه سيلازمهم ليسيطر عليهم نوع من الوسواس القهري المتعلّق بالنظافة، وعدم الثقة بالآخرين، وهل سيغدو العناق انتحاراً والقبلة قاتلة، بين أناس اعتادوا التعبير عن مشاعرهم ومحبتهم، وربما كانت هذه المشاعر وهذا الحب السلاح الذي قاوموا به كلّ ما مرّ بهم من حروب ومصائب؟
اللوحة للفنان “عدي أتاسي”
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”