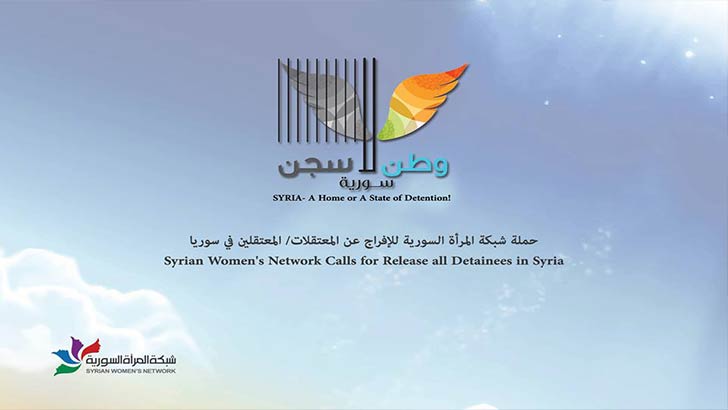“أدب السجون”؛ مصطلحٌ لا يخلو من مفارقةٍ مرّة، موجعة بين الإنسانيّ واللاإنسانيّ.. فالأدب؛ المعادل الأرقى لتطلّعات الإنسان ووعيه وتطوّره، يحمل بين طيّاته ألم الفقد والتوحّش وعذابات السجون المفتوحة أبداً على اللاإنسانيّ!..
أدب خطّته سيّاط الجلاد وقضبان الزنزانات على روح الضحيّة قبل جسدها، على خلفيّة مكان واحدٍ لا يتغيّر، وأمّا الزمان فظلمةٌ لا حدود لها ولا نهاية..
فمن المحزن حقّاً أن يكون هناك مصطلح بهذا الاسم، يخلّد هذه المعاناة وتلك الهمجيّة بآن.. ولعلّ نصيب السوريين هو الأوفر في إنتاج كمٍّ لا بأس به من أدب السجون، على مدى نصف قرن من الزمان، خلال حكم الأسدين الأب والابن، حيث ازدهر هذا النوع من الأدب، فروى قصصاً شخصيّة لمعتقلي الرأي والفكر، سواء بقلم أصحابها بعد خروجهم من الزنزانات، أم بأقلامٍ أخرى لأدباء استمعوا وعاصروا وشاهدوا هذه المعاناة التي تقشعر لها الأبدان والأرواح…
ولعلّ سجن تدمر الذي حرقته نيران “داعش”، هو الشاهد الأكبر لو بقي، على جبروت النظام الأسدي وطغيانه، وعلى عذابات آلاف السوريين منذ ثمانينات القرن الماضي حتى ساعة حرقه.. إضافة إلى شواهد أخرى لا تقلّ أهميّة، من أقبية الفروع الأمنيّة، التي حصدت، ومازالت تحصد يوميّا وعلى مدى خمس سنوات من عمر الثورة السورية، حيوات شباب ونساء وأطفال، لم يكن لهم ذنب إلا أنهم حلموا بالحرية ونادوا بها …
ولعلّ مصطفى خليفة بروايته القوقعة الصادرة عام 2008، وبتجربته الشخصيّة يعدّ نموذجا فريداً، لكنه ليس الوحيد، إذ يمكن تعميم تجربته تلك على حالة السجون في عهد الأسد الأب، فهو كاتب سوري، أمضى حوالي خمس عشرة سنة في السجن، قضى أغلبها بسجن تدمر، بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في ثمانينيات القرن الماضي..
يروي مصطفى خليفة في قوقعته قصّة شابٍّ مسيحيٍّ، اعتقل بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين، تمّ اعتقاله في مطار دمشق لدى عودته من باريس، بسبب نكتة تطال الرئيس في إحدى السهرات الباريسية، التي كان قد أُقحم في نقاشاتها السياسية ليدلو بدلوه، فانتهى به المطاف في أعتى سجون العالم قسوة، لمدة ثلاثة عشر عاماً، ذاق خلالها أنكى أنواع التنكيل والعذاب النفسيّ والجسديّ والجنسيّ..
في روايته القوقعة يروي مصطفى خليفة مشاهد رآها وعاشها لحظة بلحظة في سجن تدمر، وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً مع معتقلين سياسيين، إخوان مسلمين وشيوعيين، “قضيت هناك داخل قوقعتي في السجن الصحراوي، آلاف الليالي، أستحضر واستحلب المئات من أحلام اليقظة، كنت أمنّى النفس أنه إذا قيّض لي أن أخرج من جهنم هذه، سوف أعيش حياتي طولاً وعرضاً، وسأحقق كلّ الأحلام التي راودتني هناك، الآن ها قد مضى عام كامل، لا رغبة لديّ في عمل شيء مطلقاً، وتزداد سماكة وقتامة قوقعتي الثانية التي أجلس فيها الآن… لا يتملّكني أيّ فضول في التلصلص على أيّ كان ..أحاول أن أغلق أصغر ثقب فيها.. لا أريد أن أنظر إلى الخارج، أغلق ثقوبها لأحوّل نظري بالكامل إلى الداخل إليّ أنا إلى ذاتي وأتلصلص..”
ولعلّ الخارج الذي يحاول بطل رواية القوقعة عدم النظر إليه، هو ما وصفه بدقة الكاتب الأردني محمد سليم حماد في كتاب أصدره عام 1998، تحت عنوان “تدمر.. شاهد مشهود”، يروي فيه تجربته القاسية في السجون السورية، حيث اعتقل وهو الطالب الأردني في سنته الثانية في إحدى الجامعات السورية، لاشتباه بعلاقته مع طلبة سوريين مخرّبين ومناوئين للنظام، حيث يصف أساليب التعذيب التي تعرّض لها أو شاهدها في سجن تدمر، على النحو الآتي:
- التعليم: وهو انتقاء واحد من المعتقلين بشكل عشوائي، وتعريضه لوجبات قاسية من العذاب إلى أن يقضي نحبه، فيكون عبرة لغيره من المعتقلين.
- الدولاب: حيث يوضع المعتقل داخل دولاب مطاطي، وتُرفع قدماه في الهواء، لينهال عليه الجلادون بالسياط، ثم تُربط القدمان بسلسلة حديديّة تمنعهما من الحركة، ويلي ذلك انقضاض على المعتقل بالضرب والركل، إلى أن تسيل دماؤه.
- المراقبة الدورية: في المهجع الذي يكتظ بالمعتقلين، وهو عبارة عن غرفة مستطيلة تحتوي على دورة مياه وحمامين، وفي السقف فتحتان مغطاتان بقضبان حديدية، ويقوم عناصر المخابرات والشرطة العسكرية بالتعرّض للمعتقلين كافة أو انتقاء أحدهم، كلّما طُلب منهم بدء جولة جديدة من التعذيب.
- التفقد: وهو عمليّة الإحصاء اليومي للمعتقلين، حيث تصاحبه على الدوام عمليات ضرب وشتم وجلد، ولا يسمح لهم بالنوم إلا على بطانيات بالية، لا تقي برد الصحراء القارس.
- التنفس: حيث يعمد الجلادون إلى استغلال اللحظات التي يخرج فيها المعتقلون إلى باحة السجن، للانقضاض عليهم بالضرب بواسطة العصيّ والكابلات، ومنعهم من التحدّث إلى بعضهم. أمّا طعام المعتقلين فهو جزء من عملية الإساءة التي تصِم المعتقلات السوريّة، وخاصة سجن تدمر الصحراوي، وهي في غالب الأحيان فاسدة، وتسبب الأمراض المعويّة للسجناء، وفي بعض الأحيان يؤمر المعتقلون بأكل الذباب والصراصير والفئران الميتة تحت التهديد والوعيد.
- الحلاقة: يؤمر المعتقل بالجلوس جاثياً أمام الحلاق، وهو أحد جلادي السجن، حيث يقوم “الحلاق” باستخدام موسى جارحة مع الضرب والشتم، وغالباً ما يتسبّب بإصابة المعتقل بجروح غائرة في الرأس والوجه.
- الحمّام: حيث يخرج المعتقلون إلى باحة السجن، وينهال عليهم الجلادون بالضرب والجلد، ثم. يساقون إلى مقصورات ضمن مجموعات تضمّ كلّ واحدة نحو ستة معتقلين، تُنزع عنهم ثيابهم، وتسلّط عليهم رشاشات الماء البارد..
ويصف “محمد” في كتابه، الأجواء المرعبة التي تخيّم على معتقل تدمر، من عمليّات الإعدام المتواصلة للسجناء السياسيين، إلى جانب وفاة عدد منهم نتيجة إصابتهم بأمراض خطيرة، وعدم حصولهم على العلاج، إضافة إلى المحاكمات الصوريّة التي يقوم بـها ضبّاط الأمن والمخابرات، حيث يصدرون الأحكام العشوائية القاسية، استناداً إلى اعترافات تمّ انتزاعها تحت التعذيب. ورغم هذه الصورة المقيتة، فقد أرغم الجلاوزة السجناء، وغالبيتهم من طلبة الجامعات على التصويت بـ “نعم”، خلال حملة إعادة انتخاب الرئيس حافظ الأسد لولاية جديدة في الحكم عام 1991، ويقول “محمد”: إن الجلادين أجبروا المعتقلين على كتابة كلمة “نعم” بدمهم إمعاناً في القسوة والإذلال.
ويسلّط الكتاب/ الوثيقة، الضوء على مشاهدات عدد من المعتقلين أثناء مجزرة سجن تدمر في 27 أيار 1980، عندما أقدمت سرايا الدفاع بقيادة شقيق الرئيس آنذاك، “العقيد رفعت الأسد” على قتل ما يربو على 600 معتقل، ودفنهم في مقابر جماعية شرق تدمر.
أيضا يروي هذا الكتاب في فصوله الأولى مشاهدات صاحبه في قيادة فرع مخابرات “العدوي”، حيث كانت بداية الاعتقال، والذي سرعان ما تحوّل فيه إلى مجرّد رقم، لا اسم ينادى به غيره، ولا إشارة تدلّ عليه، ثم بدأت مراحل التحقيق، حيث عُرّي “محمد” كيوم ولدته أمّه، وتمّ تخصيص وجبتين من العذاب اليومي، لازمتاه طوال أسبوع كامل، كاد خلاله أن يقضي نحبه غير مرة، وأصيب من جرائها بما يشبه الشلل في معصميه من أثر القيود لعدة شهور تلت، وقدّر أن وزنه انخفض خلال ذلك الأسبوع خمسة عشر كيلوغراماً تقريباً!..
إلى “فرع مخابرات التحقيق العسكري”، تمّ نقل “محمد سليم” كخطوة تالية، تتابع فيها التعذيب وتنوّعت مشاهد الرعب، ففي مهجع لا تزيد مساحته عن مساحة غرفة عادية، حُشر فيها قرابة مئة معتقل، كانوا ينامون بالتناوب، تقاسمهم المكان أسرابُ القمل الفتّاكة، وعدد لا يحصى من الجرذان، التي يقسم “محمد”، أن واحدها بلغ حجم القط!.. فلمّا انتهت تلك المرحلة كانت الرحلة إلى سجن تدمر التي وصفها سابقاً بشكل مطول.
وللشاعر السوري فرج بيرقدار تجربة لا تقلّ مرارة، حيث سجن 14 عاماً… ويطلّ على السجن من شرفة الشعر.. من بشر الإنسان الأعمق.. إلى حقيقة الدولة الأكثر جلاءً.
“كثير من الكلمات قد تُستخدم لتبلغ هذا التوصيف, لكن لا شيء يشبه حقّاً طعم الفأر الميت سوى طعم الفأر الميت.. ولا شيء يشبه حقّا دموع الأب لاشتياق ابنته سوى دموع الأب, ولا شيء يشبه حقّا صعقة الكهرباء سوى صعقة الكهرباء..”.
هنا شهادةٌ تنحت المجاز وتنازع الكلمات لتفهمنا حقيقة المأساة, حقيقة تدمر, حيث كانت عقود من الصمت و.. حيث علينا جميعاً أن نشعر بالعار..
“ما الذي يعنيه أن تحسّ بالعار، ولا يتاح لك أن تغسله حتى بدمك؟
يا أين أنت كم يبدو السؤال فاضحاً ومجللاً بالخزي والخذلان!..
هل تعتقد أن المسألة تتعلّق باغتصاب امرأة مثلاً؟
تقتلني لو فكرتَ على هذا النحو.
لا اغتصاب امرأة، ولا اغتصاب ثروة أو منصب، ولا حتى اغتصاب وطن.
كلّ هذه الأمور عرضيّة وقابلة للغفران والتجاوز وردّ الاعتبار. أما اغتصاب الإنسان بإطلاق.. اغتصاب الإنسان كمفهوم.. اغتصابه كوجود!..
لا..
ليتها من حجر هذه الروح الملعونة..
اِختر لي أيّ شيء لأنتمي إليه..
خذ أيّ شيء.. خذني كاملاً.. أعني ما تبقى مني كاملاً، مقابل تبرئتي من فضيحة كوني إنساناً، من فضيحة كوني قاتلاً أو قتيلاً.
هل تصدّق أنّي أخجل من جلادي؟
ولا أبالغ إذا قلت، إنّي أخجل عنه أحياناً.
يا ألله كم يبدو هذا الوحل بشعاً ونذلاً ومقرفاً، وفي النهاية مثيراً للرثاء.
وحقّ ما كان وما سوف يكون.. لا أحمل في داخلي ضغينة على أحد، ولكن هذا الكائن ملوّث إلى آخره، ويلوثني معه.
دعك من يديه وأظافره وأسنانه.. حتى عيناه ملوثتان.. وأنت دائماً في مرمى عينيه.
قد يخيّل إليك الآن، أن المشكلة كلها تبدأ وتنتهي بهذا الجلاد المسكين، وحقيقة الأمر ليست كذلك..
هل تريدني صريحاً إلى النهاية؟
حسناً..
تخجلني هذه القابلية المرعبة للبيع والشراء.. للذلّ والمراوغة والدجل.. يخجلني هذا التواطؤ المحيِّر بين الضحية وجلادها.. هذا الحشد الهائل من السماسرة والمهرِّجين وشهود الزور.. من الوعّاظ والمريدين والجواكر والموتى وأصحاب السوابق.
وأما أنت..
بلى أنت..
فكم يخجلني.. صمتك!”….
خاتمة كتاب خيانات اللغة و الصمت – فرج بيرقدار..
ومن الكتّاب الذين أرّخوا لتجربة المعتقل في زمن الثورة السورية الأستاذ ياسين حاج صالح، وهو كاتب سوريّ معارض للنظام، وسجين سياسيّ سابق. ولد في الرقة 1961، واعتقل 16 سنة منذ 1980، بسبب نشاطه الجامعي الحزبي. يعدّ من أبرز نقّاد النظام السوري والمشتغلين بالشؤون السوريّة، إلى جانب اهتمامه بقضايا الثقافة والعلمانية ونقد الإسلام المعاصِر ونقد نقده.
اعتقل الشاب ياسين الحاج صالح من كلّيّة الطب في جامعة حلب، بتهمة الانتماء إلى حزب معارض… تنقّل بين سجن حلب المركزي ومعتقل عدرا في دمشق، مدّة خمسة عشر عاماً، وقبل أن تنتهي مدّة حكمه يُعرض عليه أن يصبح مخبراً، يكتب التقارير ويشي بأصدقائه. يرفض ياسين، ويرحَّل مع ثلاثين سجيناً إلى سجن تدمر الرهيب، ليمضي سنة إضافية في مكان جحيمي لا تنفتح أبوابه إلا لتلقي الطعام والعقاب.
زمن الثورة السورية يبدو وقتاً مناسباً للإفصاح عن هذه النصوص المؤلمة، حيث تجربة سجين ومفكّر سياسيّ عاش ستّة عشر عاماً من عمره على حافة التحطّم والخوف.
“هناك، لا أخبار جديدة، لا طعام شهياً، لا زاد عاطفياً، لا شيء طازجاً من أي نوع.. زمن آسن متجانس، أبديّة لا فوارق فيها ولا مسام لها.. سجناء يقتلون الوقت بما يُتاح من وسائل التسلية، وآخرون يروّضونه بالكتب والأقلام.. عالم بلا نساء، لا أسرار فيه ولا خصوصيات”.
من كتابه بالخلاص يا شباب – دار الساقي 2012.
انتقل أثناء الثورة إلى غوطة دمشق وغطّى بعض جوانب الحياة هناك، قبل أن يسافر إلى الرقة ويغادر إلى اسطنبول مع خريف 2013. عضو مؤسس في هامش – البيت الثقافي السوري في اسطنبول، وهو زوج الناشطة السورية سميرة الخليل التي خطفها “جيش الإسلام” في غوطة دمشق، وشقيق فراس الحاج صالح الذي خطفته “الدولة الإسلامية” في ريف الرقة.
وأيضا لدينا الأدب النسائي للسجون، حيث مازالت الزنازين تغصّ بالمعتقلات من النساء، ومنهن هبة الدبّاغ، التي روت ووثّقت القصة المؤلمة لتسع سنوات من التعذيب المتواصل… تعذيب وإذلال تقشعر له الأبدان، في كتابها “خمس دقائق وحسب”. تسع سنوات في سجون سورية”، ومن خاتمته ..
“وقتها ارتدّ بي البصر إلى دمشق عام 1985، وعدت بالذاكرة إلى ليلة رأس السنة في بيتنا بالبرامكة قبل تسع سنوات بالتحديد.. ليلة أن اصطفّت سيارات المخابرات على طول الشارع في منتصف الليل.. وسألني رئيسهم أن أذهب معه لخمس دقائق وحسب. فانتزعوني من الحياة تسع سنوات كاملات.. دون أن أعرف سببا لذلك إلى اليوم !..”، لا أتخيل نفسي بعد تسع سنوات من السجن والعذاب والأمراض الجسديّة والنفسيّة تأتي لحظة الحرية، فأشعر بالضياع لا أدري أين أذهب.. فأهلي جميعهم قتلوا إلا ثلاثة من أخوتي هاربين من جحيم الوطن، وعائلة نصفها يعملون لصالح مخابرات النظام!.. إنه الألم في أقسى صوره “.
وهبـة الدبّاغ هي الوحيدة التي بقيت من أسرتها الحموية، التي أبادوها بكاملها عام 1982، ونجت هي لأنها في السجن، وشقيقها صفوان لأنه خارج سوريا…. وقتل أزلام الأسد حوالي عشرة من أفراد أسرتها، من الأب إلى الأم إلى الأطفال الصغار والبنات الصغيرات، في مجزرة حماة الكبرى عام 1982.
ولعلّ الكاتبة والمناضلة حسيبه عبد الرحمن لديها تجربة مماثلة لتجربة هبة الدباغ، فهي المعتقلة الأشهر لحزب العمل الشيوعي ورابطته سابقاً، إلى جانب صديقتها هند قهوجي..
ففي روايتها “الشرنقة” و تاريخها عام 1999، بلا ناشر. ومنذ الصفحة الأولى، تبدأ تصفعنا بوّابة حديدية وعصابة للعيون ودولاب وكرسيّ التعذيب الشهير، وزنزانة للنساء السياسيّات وغير السياسيّات.
الراوية هنا هي كوثر التي بات اسمها الحركي “سناء” في التنظيم السرّي الذي انتسبت اليه، والراوية تقصّ علينا قصص زميلاتها المعتقلات من التنظيم نفسه، وتقصّ أيضا قصصاً عن أجدادها الشيوخ المتمردين، وسيرة طفولتها واعتقالاتها المتكررة، وصولاً إلى الاعتقال الأخير الذي ستكابده سنوات حتـى تخرج – مع سواها – من جوف الغولة مردّدة: “ضريبة كلّ امرأة ترفع رأسها قليلاً، إذا فشلت السلطات بتدميرها.. دمّرها الأقربون”.
في جوف الغولة – السجن تتوزع النساء بين غرفة القتل – أي القاتلات – والمخدّرات والسياسيّات والعابرات، اللواتي يأتين فجأة من دعارة الفنادق الرخيصة والبيوت الفقيرة، ويختفين فجأة. وفي هذا الجوف تلد سجينة امتدت يدها إلى خزينة المؤسسة الاستهلاكية. ولأن حملها غير شرعي، تحيا وليدتها “براءة” معها وسط “صندوق دنيا من لحم ودم”، كما تصف الكاتبة هذا العالم النسويّ العجائبي، حيث فرش الإسفنج والسحاحير وعفن الآباط والشراشف من كلّ لون، وحيث السهر أمام التلفزيون ودروس محو الأميّة والشجار من أجل نشر الغسيل، مثل الاحتفال برأس السنة أو بتأسيس التنظيم السري، أو عرض الأزياء في السجن، أو تسرّب أخبار الرفاق السجناء.
تستعيد “الشرنقة” تلك التجارب المريرة بعد خروج الراوية ورفيقاتها والأصوليات من السجن. إنّ بناء “الشرنقة” يظلّ شهادة – سيرة ذاتية – ربما – عمّا بلغه القمع السوريّ، وعلى المكابدة التي قدمتها المرأة، شأنها شأن الرجل، جرّاء المعارضة، أيّة معارضة… وإذا كانت الغولة قد التهمت أولاد العنزة، كما في الحكاية التي تختم “الشرنقة”، فما الذي تغيّر في الأولاد بعد خروجهم من جوف الغولة .؟؟؟؟..
أما الروائية روزا ياسين حسن في روايتها “نيغاتيف” الصادرة عام 2007، فقد رصدت عشرات التجارب لمجموعة من المعتقلات اليساريات والإسلاميات السوريات، اللائي تمّ اعتقالهن في الفترة من أواخر السبعينيات حتى أواخر التسعينيات؛ حيث تمّ جرّهن للمعتقلات بحجّة الانضواء تحت أحزاب معارضة للنظام الحاكم، أو أخذهن كرهائن بديلاً عن الأزواج والإخوة، خصوصا بعد المذابح الشهيرة التي أقامها النظام السوري الحاكم حينها للمعارضين السوريين بكافة طوائفهم، وعُلقت المشانق للكثيرين منهم.
تبدأ روزا ياسين حسن روايتها تحت عنوان “بمثابة مقدمة” بمقولة للكاتب سـعد الله ونوس في مســرحيتة “منمنمات تاريخية”، يقول فيها آزدار، آمر قلعة دمشق، عندما اجتاح تيمورلنك دمشق: “إني أتحصّن في هذه القلعة، كي لا يقال في قادم الأيام اجتاح تيمورلنك هذه البلاد ولم يوجد من يقاوم”..
تقول الكاتبة روزا ياسين: إن تجربة المعارضة السياسيّة في بلاد الديكتاتوريات وبمختلف أطيافها، جزء لا يتجزأ من هذا النسق الذي قال عنه بريشت: غداً لن يقولوا: كان زمناً صعباً، بل سيقولون: لماذا صمت الشعراء؟! حيث ترى روزا أن التجربة النسائيّة بين صفوف المعارضة تؤكد ذلك، وما تجربتها في الكتابة عن الاعتقال إلا انسحاب لإجهار الصوت في زمن الصمت، حين تتحوّل الأنوثة بمعناها التاريخي النظريّ والمكرّس، لتصبح قادرة على الوقوف بوجه الطغيان وظلمة المعتقلات.
عدّت روزا روايتها هذه محاولة لتدوين جزء من تاريخ نسويّ سياسيّ، غُيّب سنين طويلة كما غُيّبت تجربة المعارضة عموماً وبمختلف أطيافها.
“كان من الصعب أن تظهر الأيديولوجيات ويتمّ استحضارها في المعتقل في هذا الوضع المأساوي؛ حيث كلّ الحقائق حينها تتراجع لصالح الحياة والبقاء، وحيث الرموز والتابوهات والمذاهب تتلاشى من أجل شربة ماء أو قصعة برغل طعمها شبيه بزيت السيارات، أو من أجل بطانية للتدفئة، أو حتى من أجل أن تتسلّل المعتقلة على أطراف قدميها خفية لتقضي حاجتها في غيبة من الحراس والسجّانين.
حيث لا يجد الإنسان نفسه بالتعذيب والقهر المتواصل إلا وهو يتراجع عن إنسانيته حتى حيوانيته. فالأفكار لا تتواجد حيث تحاول المعتقلة أن تناضل لكي تتحمّل التعذيب، لتهرع بعدها لزنزانتها شاكرة ربّها ثم جسدها أن عاوناها على أن بقيت حيّة بدون أن تفكّر في أية تبعات إنسانية، وأحيانا تصل أن لا تفكّر في الطعام، تجاهد لتبقى، ولتبقى فقط!..”
“المرجعيات تتلاشي تحت سقف زنزانة ضيّقة ضيق الجحر، والمعتقلات يعشن فيها ملتصقات، نصفهن نائم بشكل التسييف (عقب ورأس)، كل منهما تحتضن أقدام الأخرى، بينما النصف الآخر واقفات على الباب ينتظرن بفارغ الصبر استيقاظ الأخريات كي يستطعن النوم..”.
هذا غيض من فيض لبضع شهادات من بين آلاف المعتقلين قبل الثورة، وربما سيكون هناك مستقبلاً، مجلدات من قصص لمعتقلي الثورة السوريّة، وللأسف ممّن سيبقى منهم على قيد الحياة ولا يكون كآلاف غيره شهيداً تحت التعذيب…
الجزء الثاني من كتيب حملة “سوريا وطن لا سجن”