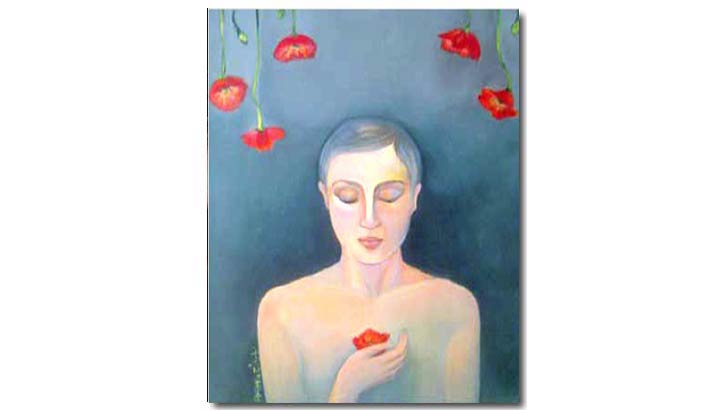أمينة بريمكو
كنت أراجع ذاكرة الثّلج، الّذي كان يرتديني في صيفٍ جامح. غابت هواجس الكتابة، وراء خيمة القلق، دون أن أعير أنوثتي الغائمة وراء ستائر القدر. عندما فتحت دفاتر الماضي، وجدتني غائبة عن الوعي فوق مقعد ٍمنسي في إحدى الحدائق المهجورة. حينها صمّمت أن أغازل مشاعري, اهتم ّبتدريب حواسي، أعزف كأيّة امرأة على آلة الجموح. تدفّقت مئات الأسئلة المتراكمة في بهو الحاضر، ارتديت قميصاً ورديّاً، تعطّرت برائحة الجرأة، لبست قناعاً من المساحيق، خرجت إلى أحد المقاهي، الّذي يجتمع فيه عدد من الأصدقاء. كنت قد مرّنت نفسي أمام المرآة، كيف عليّ أن أبدو كأنثى، الشّارع يمطر أنظار المارة، تيقّنت بأنّني سألد اليوم وردة.
جلست في إحدى الزّوايا، فتحت جريدة الأمس، فردتها كلّها، أثناء قراءتي لإحدى الزّوايا، سألني النّادل عمّا أشرب، نظرت إليه بعفويّة قلت: “هل لديكم عصير الفواكه؟” ابتسم النّادل وقال: “سيدتي أنت في مقهى، لدينا قهوة وشاي وهورات”. تصفّحت الوجوه، شعرت بهم جميعاً، يحملون وجهاً واحداً، هوية واحدة، كونهم جميعاً ذكوراً. اقترب أحدهم، وهو كاتب قصّة شهير، قال:”ليست من عاداتك الجلوس في المقاهي ، ما الّذي تغيّر؟” أصابتني وعكة غباء، قلت: “هل أبدو مختلفة بنظرك؟”. ابتسم: ” تبدين كعادتك، امرأة قويّة ” ثمّ اعتذر وهو يقول:” الآن ستأتي صديقتي، عليّ انتظارها”.
وأنا أعيد صياغة ذاتي ، أبحث عن مفاتيحي الضّائعة في غابة الأشياء الّتي كانت تثيرني، اكتشفت أنّني كنت دائماً أزايد على قدري. ما حاولت يوماً، أن أروّض أفكاري، أمنحها إجازة، كنت أركض في أنفاق الوطن، الّذي كان يهرب، وهو يمتطي صهوة الوهم. تذكّرت اللّوحة الشّاحبة، الّتي كانت تزيّن جدران حياتي، عندما كان المحقّق يستجوبني، بين كلّ سؤال، وآخر يطلق شتيمة. قبل أن أفهم معنى الألم، كنت ملقاة على أرضية، مضمّخة بدماء جافّة، يداي مكبّلتان، هناك أكثر من ثلاثة رجال، عريضي المنكبين، كلّ واحد ينتظر دوره، في رسم خارطة الوجع فوق جسدي الصّغير. فهمت دروس الموت، ولماذا يقولون المرأة خلقت للبيت وتربية الأولاد، بينما الرّجل خلق ليؤمّن لقمة العيش ويبني الأوطان. ترى هل بقيت في تلك الغرفة لساعتين أم ثلاث؟ فيما بعد ، وأنا خارج السّجن، كانت ماهية أن أتدرّب على دوري الأساسي ّفي هذه الحياة، نوع من العبث … هل كانت الكتابة فخّاً آخراً للحيلولة دون لعب دوري كأنثى؟
أتصفّح الجريدة دون أن أعير الأحرف أيّة أهمية، اقترب صديق آخر، جلس قبل أن يستأذنني، قال: ” كاتبتنا العظيمة وهي تخرج من صومعتها، ماالّذي حصل؟” نظرت إلى عينيه الفارغتين كأنّهما عينا سمكة، أجبته: “ربّما لدي مشروع كتابة، يستوجب الجلوس في أحد المقاهي”. قال ونبرة الخبث تلازم صوته: “الكتابة أم لأنّك مللت حياة العزلة، تودّين أن تعيشي كما جميع البشر؟” كانت زاويتا فمه رخوتين، تعكسان لديّ أسوأ إحساس. فضّلت الصّمت وإذ به يتراجع إلى مائدته، فكّرت: ألم يكن هذا الرّجل، هو نفسه الّذي كتب أجمل رواية إنسانيّة، بيعت كلّ نسخ روايته في أنحاء البلاد؟ لماذا عليه أن يبدو كالجميع؟ يتزوّج من امرأة كلاسيكيّة، ويتحوّل إلى تاجر؟
هل كانت سنواتي السّابقة مرهونة في زجاجة الانتظار، وأنا مهدّدة منذ ولادتي بكلمة لا؟ كيف أسيج عمراً عارياً، تعصفعه رياح البقاء؟ لم أصرخ يوماً إلاّ وأنا ممدّدة في زنزانة مظلمة، تعلوها عرائش الرّعب، كيف لم أكتشف الذّكورة ، إلاّ ونأنا مكبلة اليدين، والدماء تسيل من زوايال الدّماء تسيل من فتحتي أنفي، هناك من يجثم فوق جسدي، يلفّ خصلاتي المضمّخة بدماء جافّة. فيما بعد كان عليّ أن أعاقب أنوثتي، أكتب المئات من القصائد عن أصابع الذّكورة، الّتي كانت تدمي مشاعري، تذبح أفكاري، كيف أن هؤلاء الرّجال، يستطيعون أن يحطّموا الإنسان، ويّدعون بأنّهم صانعو الحياة على هذا الكوكب؟
أجاهد أن أبدو كأنثى، وإذ برجل يبدو في الأربعين، يراقبني بإعجاب. كانت ملامحه تبدو أكثر من مبهمة، ربّما لنظارته الكبيرة دور في إخفاء حقيقته. فتحت حقيبتي، تأمّلت وجهي في المرآة الصّغيرة الّتي وضعتها لأوّل مرّة في حقيبتي، كنت أبدو كمهرجة ربّما لأنّها المرّة الأولى الّتي أرهق وجهي بالمساحيق، الّتي اشترتها لي أختي قبل عشر سنوات، بعد خروجي من السّجن. لم أعرفني, كأنّني أرى امرأة أخرى، عيناي تبدوان كعيني ضفدعة كهلة، خداي كحبّتي طماطم، شفتاي كمؤخرة قرد، قبل أن أغلق الحقيبة، جاءني الرّجل وقال: “ألست الكاتبة …؟” قلت :” نعم” قال وصوته يشي بفرحة عارمة:” قرأت كلّ دواوينك، وقصصك، تمنّيت دائماً أن ألتقي بك وأسالك سؤالاً واحداً فقط”.
أثارتني جرأته، تنبّهت إلى بشرته، وكميّة البثور الّتي شوّهت بشرته. لا أعلم لماذا أحببت أن تحدث مشكلة ما ولا أسمع سؤاله، لكنّه كان قد لفظها:” لماذا تحاولين في كلّ أعمالك أن تمنحي أبطالك قدراً كبيراً من الألوهيّة، تجرّدينهم من كونهم بشراً؟”
كنت أتذكّر وجهي، وكميّة القباحة الّتي رسمتها بأدوات خلقت للنساء، فكّرت: ” ترى لأيّة درجة يستطيع هذا الرّجل تحمّل وجهي ولا يتقيّأ؟”. عندما طال انتظاره في سماع الجواب، قال : “كأنّك من كوكب آخر”. تفتحت أزاهير الرّضا فوق ذاتي قلت: “حقّاً؟” قال : “نعم أنت المرأة الّتي تستطيع أن تسكن قصر الخلود”. شعرت، ببلادة عبارته، وأنا أراقب بثور بشرته، رن هاتفه النّقال، إذ به يقول: “هل عليّ أن أبرهن لك كلّ يوم بأنّك ملكتي و…”. اهتممت بقراءة جريدتي، تمنّيته أن يرحل بسرعة، كأنّه تنبّه لأمنيتي، اعتذر عن فضوله ورحل، عندما شعرت، بأنّني فشلت في لعب دور الأنثى، قرّرت الانسحاب من المكان المكتظّ بالرّجال، الّذين يحملون وجهاً واحداً، روحاً واحدة.
تعثّرت بكتفي رجل أعرفه جداً، يعرفني جداً، قبل أن ألقي التّحية عليه، تأبّط ذراعي، وهو يقول: “إنّها أجمل مفاجأة حصلت لي منذ ولادتي، أين كنت أيّتها اللّعينة؟ وكيف قضيت كلّ هذه السّنوات بدوني؟”. كان هذا الرّجل هو الرّجل الوحيد الّذي أحبّني، لم أهتمّ يوماً لمشاعره، عند خروجي من السّجن، كان قد تزوّج من ابنة عمه، وسافر إلى الخارج، كانت ألوان الشّباب قد طليت بطلاء الذّبول؛ عيناه الكبيرتان، تسكنهما غابة شائكة، مشينا معاً في الشّارع، كان بين الحين والآخر، يحاول عبر مفردات ذكيّة، أن يبرهن لي عن سبب زواجه من أخرى ، وهروبه إلى الخارج. قبل أن يودّعني، قال بنبرة حادّة: “ما زلت تلك المرأة الّتي عرفتها لأوّل مرّة ، قويّة، تحلّقين عالياً، فوق رؤوس البشر، تستحقّين كلّ النّجاحات الّتي حقّقتها في المجال الإبداعيّ”.
دخلت المنزل، وأنا أودّعه أمام الباب، قلت لنفسي، بصوت عالٍ:” ما دامت كلّ النّفوس الّتي في الخارج ، تشبه بعضها، لماذا أشتهي فعالياتهم؟ لماذا لا أموت وأتخلّص من كلّ تلك التّفاهة الّتي تنتظرني في الخارج؟”. تناولت علبة كاملة من المهدئات.
ها أنا محاطة، مرّة أخرى بالآخرين، بعد أن سمحت أختي، لكل ّوسائل الإعلام، بأن تأتي وتلتقط صور موتي، لتمنح بعض الشّهرة لنفسها، كونها أختي.
قصة قصيرة من المجموعة القصصية”لقيطة الأرصفة” عن دار سما دبي